إنه دم الدعــوة

إنه دم الدعـــــــــوة
الشيخ : محمد أحمد الراشد
يعتبر تاريخ الصدر الأول من السلف الصالح من مصادر فقه الدعوة الرئيسة، فإنهم بأفعالهم وطريقتهم في الحياة كانوا أفصح من خلف ينطلق بقلمه لتدوين فقه الدعوة من تأمل نظري مجرد. وقد حددوا بسيرتهم ما يجب للداعية من صفات، وما يسوغ للدعوة أن تسلمه من أساليب ووسائل.
فبعضهم لم يتكلم بغير حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا جملا يسيرة، ولكنه أرى الناس تطبيقا رائعًا للحديث وأفعالا شدتهم إلى الاقتداء.
وإنما يرجي لدعوة الإسلام النجاح اليوم إذا أدركت هذه الحقيقة القديمة، لا بشيء آخر، فتحرص على أن تنزل ساحة العلمانية كل جوال فعال صامت، يري الأرضيين من نفسه قوة، قبل أن يسمعهم من لسانه تفاصحًا.
ومحمد بن سيرين، التابعي البصري: قدوة من قدوات الصمت الناطق أولئك، وله مذهب في التجرد سماه صاحبه أبو قلابة الجرمي: امتلاك النفس، فقال يفاخر بابن سيرين جمعا من الدعاة:
إصرفوه حيث شئتم، فلتجدنه أشدكم ورعًا، وأملككم لنفسه
فالداعية يملك نفسه، ومن ثم فهو الذي يخطط لها طريقها ومستقبلها، ولا يدعها تملكه، فإن من لم يملك نفسه: يفقد حريته، وتكون هي المستعبدة له، وإنما هذه دعوة الأحرار والأبرار، يتصدرها كل حر سريع الخطو، ومن رضى أن يكون مملوكا ويرسف في الأغلال والقيود فإنما يكون في آخر القافلة، أو تدعه وتمضى.
ومنذئذ أضيف إلى فقه الدعوة شرط جديد من شروط الدعاة يلزم المتصدي أن يملك نفسه كما ملكها ابن سيرين، وأن يحررها من القيود كما حررها ابن سيرين.
وقد قال ابن السماك من قبل:
إن الرجاء حبل في قلبك، قيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك: تحل القيد من رجلك
ويقصد بالرجاء: الأمل الدنيوي، فإنه يقيد الرجل عن الانطلاق في أعمال تتطلب التضحية وتضع إزهاق الروح واردًا في الاحتمال.
إنما ذلك الواهم فقط يغريه الأمل، أما الفطن فيدرك أنها قافلة ليست ككل قافلة، ويعلم أنها قافلة النور هو فيها، وأنها تسير في درب كله نور، قد توغلت فيه، فيحل قيود الطمع ويواكبها، ويلازم أهلها إذ يرفعون أبصارهم إلى هالة النور السابع، هو:
فينشغل الداعية بإصلاح عيوبه، ويدع إعابة الآخرين، وتسقط زلاتهم.
وكان السري السقطي البغدادي يتخوف خوفا عظيما من سريان مرض تتبع عيوب الناس إلى جماعة السالكين إلى الله، فكثر تحذيره منه، وصنع إحصاءات خلقية اجتماعية لبيان مدى تأثيره السيئ وإظهار تعدد أنواع سلبياته، ووضع تقريرًا طويلا حفظت لنا منه كتب الزهد والرقائق فقرات منه كثيرة، وأجمل في خاتمته نتيجة استقرائه فقال:
ما رأيت شيئا أحبط للأعمال، ولا أفسد للقلوب، ولا أسرع في هلاك العبد، ولا أدوم للأحزان، ولا اقرب للمقت، ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه، ونظره في عيوب الناس.
فهي سلبيات يعددها، كل منها يكفي لتعكير صفو السكينة الإيمانية.
وقد أشار في مقدمة تقريره إلى أن: من علامة الاستدراج للعبد: عماه عن عيبه، واطلاعه على عيوب الناس.
فجعل بدايته: استدراجًا، أي تغريرًا من شيطان، يمني ضحيته بوجود بعض لذة في آخر طريق وعر بعيد ويغريها بنيلها، فتلج، فتنقطع، فينفرد بها بلا نصير أو ظهير، فيقهرها، كما يقهر الجيش أعداءه الضعاف بإظهار تراجع مفتعل يغريهم بالتوغل دون حساب خط رجعة.
ولما نودي على السري بعد ذلك للولوغ في أعراض الناس وولوج مجالس إحصاء عيوب الآخرين ناداهم بأعلى صوته:
إن في النفس لشغلا عن الناس.
وإنها لصيحة حق لها أن يصرخها كل دعاة الإسلام الآن، والخبير بتلبيس إبليس يدرك مزالق هذا الباب جيدًا.
فأجرأ من رأيت بظهر غيب .. على عيب الرجال: ذوو العيوب
حتى باتت هذه الخصلة فاضحة لكل ذي لسان طويل، مغنية عن الفراسة، فقال السامع للمهذار:
قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلب بقدر ما فيه منها.
ولذلك كان السلف عموما على أشد الخوف من هذا الخلق الردئ الذي قد يلبسه إبليس رداء النصح والأمر بالمعروف، وصاحب القلب الحي يميز هذا عن هذا بوضوح، لكنها الغفلة التي ابتأس لها التابعي عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود حين كان يساعد أخاه عبيد الله في تطبيق نظرية تأليف الأرواح، فقال:
ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه.
فالغفلة سبب ظاهر ولا شك، لولاها لاعتنى بملكه، ولشغله الغرس وجنى الثمار.
أما أهم أعراض مرض الغمز فهو تواصي مرضاه بإخفاء مناقب الغير وفضح هفواتهم.
رآهم كذلك النسابة البكري، فقال لرؤبة بن العجاج: ما أعداء المروءة؟
قال: تخبرني
قال: بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستره، وإن رأءا سيئا أذاعوه.
ورآهم الشاعر أيضًا، فتعجب من حالهم وكيف أنهم: إن يسمعوا الخير: يخفوه، وإن سمعوا شرًا: أذاعوه، وإن لم يسمعوا: كذبوا
ولا شر عند جماعة المؤمنين والحمد لله، لكن ذلك خلقهم دائما، لا يعجبهم ما عليه المؤمنون من الخير، فإن حدثت هفوة يعلمون ما وراءها من نية صادقة: طبلوا وزمروا.
ومن أعراض هذا المرض أيضًا: التهويل والمبالغة، واستعمال العدسة المكبرة للتفتيش عن صغائر الغير.
ذكر أبو هريرة رضي الله عه ذلك عنهم، فقال لهم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عين نفسه
ثم رأى الشاعر منهم معاندا بأبي الإنصاف، فجدد له قول أبي هريرة، ووبخه، وقال له:
وتعذر نفسك إما أسأت .. وغيرك بالعذر لا تعذر!
وتبصر في العين منه الذي .. وفي عينك الجذع لا تبصر!
علاج الهمز برقابة القريب
ولكن ما جعل الله من داء إلا وجعل له من الأدوية ما يذهب به.
وكأي مرض نفاقي آخر فإن الهمز يداوي أول ما يداوي بتذكر رقابة الله، فإنه الدواء العام الخاص، فيعلم أن الله نم قلبه قريب، وعلى لسانه رقيب، ويسكت تائبا، ويعزف عن صاحبه لو أتاه من الغد يدعوه إلى جلسة غيبة، ويشرح أمره، ويحدثه عن النور الذي أناره الله في قلبه فأضاء زاوية كانت فيه مظلمة، ويقول له:
يمنعني من عيب غيري الذي ***أعرفه عندي من العيب
عيبي لهم بالظن مني لهم***ولست من عيبي في ريب
إن كان عيبي غاب عنهم فقد***أحصى ذنوبي عالم الغيب
ويقول صريحة لصاحبه، ويهدده محذرًا:
لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا***فيكشف الله سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا***ولا تعب أحدًا منهم بما فيكا
فإن لم يصغ له: تركه، ومضى في طريق الأنوار، يبدد ما قد يكون هنالك من بقايا الظلام بنور النصح مع الله الذي أوقده له زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم لما قال:
إذا نصح العبد لله تعالى في سره: أطلعه الله تعالى على مساوي عمله، فتشاغل بذنوبه عن معايب الناس.
فزين العابدين يجعل معرفة المسلم بعيوبه منحة ربانية، و أنها لكذلك والله.
فإذا قرن التائب سكوته ونصحه لله بدعاء يتضرع فيه: كما نوره السابع.
ويستحب له هنا أن يكون خلف عبد الوهاب عزام، يردد مناجاته ربه:
إن في النفس بغضه لأناس***اصلحني وحببنهم إليا
واغسل الحقد والهوى من فؤادي***واجعلني لكل حق وليا.
يقول آمين، وينطلق من فوره بعد ذاك لإتمام أنواره، ويندفع نحو ومضات: النور الثامن، وهو:
صون الأذن عن استماع الغمز
فيدعها في عافية من بعد ما عافى لسانه من تتبع زلات الناس وانتبه لعيوب نفسه، إذ:
ليس من جارحة أشد ضررا على العبد –بعد لسانه- من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب، وأقرب وقوعًا في الفتنة.
فسمعك صن عن قبيح الكلام***كصون اللسان عن النطق به
فإنك عند استماع القبيح***شريك لقائه فانتبه
وهذا ما يستدعيه التعجل الإيماني المستحب للسائر في طريق الأنوار، فإن استماعه للهماز يضيع عليه وقته الثمين إن لم يضره، ويفوت عليه الالتذاذ بمنظر شروق: النور التاسع، الساطع ببريق:
المسارة في نصيحة القادة
فلما لم يعط النبي -صلى الله عليه وسلم- جعيل بن سراقة الضمري رضي الله عنه شيئا من المال، وهو المهاجر المجاهد، وأعطى من هو دونه، وظنها سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه إهمالا لجعيل، وأراد توثيقه: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- مقترحًا:
قال سعد: فساررته قلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلمًا.
فذكر ابن حجر أن هذا الحديث يتضمن من الفقه:
أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان
قال: وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة.
ولما طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكلم بعض الأمراء حول أمر ضجروه منه قال: إنكم لترون أني لا أكلمه؟ إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه؟.
فأخبرهم أنه لم يغفل عن ذلك، وأنه كلمه، ولكن في السر، خوفا أن يستغل أهل الأهواء كلامه، فيتخذونه ذريعة إلى الفتن والمفاسد.
فلهذا يسمي هذا النور: نور أسامة، وما زال يتولي إيقاده من دعاة اليوم كل أسامة.
وراموا دم الإسلام لا من جهالة***ولا خطأ، بل حاولوه على عمد
ففي حلقة دراسية انعقدت في المدينة لتدريب وتفقيه الجيل الجديد من رجال دولة الإسلام المكلف باستدراك ما صنعته الفتنة: حاضر عبد الله بن عكيم، وطفق يلخص لهم تجارب المخلصين فقال: لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان.
وكانت كلمة مثيرة منه حقا.
وتأخذ الجميع إطراقة، فما ثم إلا عيون تتبادلا لنظر مستغربة ما يقوله الرجل الصالح.
ما لهذا الشيخ البرئ المؤمن الذي لم يرفع في وجه عثمان سيفا أبدًا يتهم نفسه ويلومها على ما لم يفعل؟
وينبري جزئ لسؤاله:
يا أبا معبد: أو أعنت على دمه؟
فيقول: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه.
فهو يتهم نفسه بجزء من دم عثمان لأنه رأى بأم عينه كيف أن ما ظنه وقام في نفسه من أنه الحق قد أدى إلى استغلال الرعاع له حين يتكلم به، وكيف طوروه حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه.
إنها حساسية النفس الصادقة في توبتها ينطق بها ابن عكيم، مع أنه ما كان يكره عثمان حين تفوه بتلك الكلمات، فإن ابنه يقول: كان أبي يحب عثمان.
وهذا يقتضي أنه قال كلماته الناقدة بلهجة المحب وما فيها من الرفق واللين، ومع ذلك نتج عنها من المفاسد ما نتج، فكيف لو أنضاف إلى علانية النقد لفظ ردئ، وعبرت عنه لهجة عنيفة؟
إن الجيل الجديد من رجال دعوة الإسلام الحديث –إذ هو يتفقه اليوم في حلقاته الدراسية لاستدراك ما صنعته فتن الأمس- مدعو إلى ملاحظة المغزى العظيم المهم لقصة عبد الله بن عكيم، وتجربته الصادقة.
لا تكن ساذجًا أيها الداعية، فإنها تحريشات من حولك لسفك دم الدعوة.
احذر، والتفت إلى عيب نفسك، وصن سمعك وسارر بنصيحتك ونقدك، ولا تعن بلسانك.
يعتبر تاريخ الصدر الأول من السلف الصالح من مصادر فقه الدعوة الرئيسة، فإنهم بأفعالهم وطريقتهم في الحياة كانوا أفصح من خلف ينطلق بقلمه لتدوين فقه الدعوة من تأمل نظري مجرد. وقد حددوا بسيرتهم ما يجب للداعية من صفات، وما يسوغ للدعوة أن تسلمه من أساليب ووسائل.
فبعضهم لم يتكلم بغير حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا جملا يسيرة، ولكنه أرى الناس تطبيقا رائعًا للحديث وأفعالا شدتهم إلى الاقتداء.
وإنما يرجي لدعوة الإسلام النجاح اليوم إذا أدركت هذه الحقيقة القديمة، لا بشيء آخر، فتحرص على أن تنزل ساحة العلمانية كل جوال فعال صامت، يري الأرضيين من نفسه قوة، قبل أن يسمعهم من لسانه تفاصحًا.
ومحمد بن سيرين، التابعي البصري: قدوة من قدوات الصمت الناطق أولئك، وله مذهب في التجرد سماه صاحبه أبو قلابة الجرمي: امتلاك النفس، فقال يفاخر بابن سيرين جمعا من الدعاة:
إصرفوه حيث شئتم، فلتجدنه أشدكم ورعًا، وأملككم لنفسه
فالداعية يملك نفسه، ومن ثم فهو الذي يخطط لها طريقها ومستقبلها، ولا يدعها تملكه، فإن من لم يملك نفسه: يفقد حريته، وتكون هي المستعبدة له، وإنما هذه دعوة الأحرار والأبرار، يتصدرها كل حر سريع الخطو، ومن رضى أن يكون مملوكا ويرسف في الأغلال والقيود فإنما يكون في آخر القافلة، أو تدعه وتمضى.
ومنذئذ أضيف إلى فقه الدعوة شرط جديد من شروط الدعاة يلزم المتصدي أن يملك نفسه كما ملكها ابن سيرين، وأن يحررها من القيود كما حررها ابن سيرين.
وقد قال ابن السماك من قبل:
إن الرجاء حبل في قلبك، قيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك: تحل القيد من رجلك
ويقصد بالرجاء: الأمل الدنيوي، فإنه يقيد الرجل عن الانطلاق في أعمال تتطلب التضحية وتضع إزهاق الروح واردًا في الاحتمال.
إنما ذلك الواهم فقط يغريه الأمل، أما الفطن فيدرك أنها قافلة ليست ككل قافلة، ويعلم أنها قافلة النور هو فيها، وأنها تسير في درب كله نور، قد توغلت فيه، فيحل قيود الطمع ويواكبها، ويلازم أهلها إذ يرفعون أبصارهم إلى هالة النور السابع، هو:
الالتفات إلى عيب النفس
فينشغل الداعية بإصلاح عيوبه، ويدع إعابة الآخرين، وتسقط زلاتهم.
وكان السري السقطي البغدادي يتخوف خوفا عظيما من سريان مرض تتبع عيوب الناس إلى جماعة السالكين إلى الله، فكثر تحذيره منه، وصنع إحصاءات خلقية اجتماعية لبيان مدى تأثيره السيئ وإظهار تعدد أنواع سلبياته، ووضع تقريرًا طويلا حفظت لنا منه كتب الزهد والرقائق فقرات منه كثيرة، وأجمل في خاتمته نتيجة استقرائه فقال:
ما رأيت شيئا أحبط للأعمال، ولا أفسد للقلوب، ولا أسرع في هلاك العبد، ولا أدوم للأحزان، ولا اقرب للمقت، ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه، ونظره في عيوب الناس.
فهي سلبيات يعددها، كل منها يكفي لتعكير صفو السكينة الإيمانية.
وقد أشار في مقدمة تقريره إلى أن: من علامة الاستدراج للعبد: عماه عن عيبه، واطلاعه على عيوب الناس.
فجعل بدايته: استدراجًا، أي تغريرًا من شيطان، يمني ضحيته بوجود بعض لذة في آخر طريق وعر بعيد ويغريها بنيلها، فتلج، فتنقطع، فينفرد بها بلا نصير أو ظهير، فيقهرها، كما يقهر الجيش أعداءه الضعاف بإظهار تراجع مفتعل يغريهم بالتوغل دون حساب خط رجعة.
ولما نودي على السري بعد ذلك للولوغ في أعراض الناس وولوج مجالس إحصاء عيوب الآخرين ناداهم بأعلى صوته:
إن في النفس لشغلا عن الناس.
وإنها لصيحة حق لها أن يصرخها كل دعاة الإسلام الآن، والخبير بتلبيس إبليس يدرك مزالق هذا الباب جيدًا.
أسباب مرض الغمز وأعراضه
والذين رصدوا أسباب هذا المرض الخبيث يؤكدون أنه ظاهرة دفاع عن النفس ليس إلا، فأصحاب العيوب يتوقعون نقدا لهم من ناصح أمين يظنونه مهاجمًا، فيتداعون إلى أخذ زمام المبادرة وتحويل الهجوم بهمز ولمز من وراء ظهر.فأجرأ من رأيت بظهر غيب .. على عيب الرجال: ذوو العيوب
حتى باتت هذه الخصلة فاضحة لكل ذي لسان طويل، مغنية عن الفراسة، فقال السامع للمهذار:
قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلب بقدر ما فيه منها.
ولذلك كان السلف عموما على أشد الخوف من هذا الخلق الردئ الذي قد يلبسه إبليس رداء النصح والأمر بالمعروف، وصاحب القلب الحي يميز هذا عن هذا بوضوح، لكنها الغفلة التي ابتأس لها التابعي عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود حين كان يساعد أخاه عبيد الله في تطبيق نظرية تأليف الأرواح، فقال:
ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه.
فالغفلة سبب ظاهر ولا شك، لولاها لاعتنى بملكه، ولشغله الغرس وجنى الثمار.
أما أهم أعراض مرض الغمز فهو تواصي مرضاه بإخفاء مناقب الغير وفضح هفواتهم.
رآهم كذلك النسابة البكري، فقال لرؤبة بن العجاج: ما أعداء المروءة؟
قال: تخبرني
قال: بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستره، وإن رأءا سيئا أذاعوه.
ورآهم الشاعر أيضًا، فتعجب من حالهم وكيف أنهم: إن يسمعوا الخير: يخفوه، وإن سمعوا شرًا: أذاعوه، وإن لم يسمعوا: كذبوا
ولا شر عند جماعة المؤمنين والحمد لله، لكن ذلك خلقهم دائما، لا يعجبهم ما عليه المؤمنون من الخير، فإن حدثت هفوة يعلمون ما وراءها من نية صادقة: طبلوا وزمروا.
ومن أعراض هذا المرض أيضًا: التهويل والمبالغة، واستعمال العدسة المكبرة للتفتيش عن صغائر الغير.
ذكر أبو هريرة رضي الله عه ذلك عنهم، فقال لهم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عين نفسه
ثم رأى الشاعر منهم معاندا بأبي الإنصاف، فجدد له قول أبي هريرة، ووبخه، وقال له:
وتعذر نفسك إما أسأت .. وغيرك بالعذر لا تعذر!
وتبصر في العين منه الذي .. وفي عينك الجذع لا تبصر!
علاج الهمز برقابة القريب
ولكن ما جعل الله من داء إلا وجعل له من الأدوية ما يذهب به.
وكأي مرض نفاقي آخر فإن الهمز يداوي أول ما يداوي بتذكر رقابة الله، فإنه الدواء العام الخاص، فيعلم أن الله نم قلبه قريب، وعلى لسانه رقيب، ويسكت تائبا، ويعزف عن صاحبه لو أتاه من الغد يدعوه إلى جلسة غيبة، ويشرح أمره، ويحدثه عن النور الذي أناره الله في قلبه فأضاء زاوية كانت فيه مظلمة، ويقول له:
يمنعني من عيب غيري الذي ***أعرفه عندي من العيب
عيبي لهم بالظن مني لهم***ولست من عيبي في ريب
إن كان عيبي غاب عنهم فقد***أحصى ذنوبي عالم الغيب
ويقول صريحة لصاحبه، ويهدده محذرًا:
لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا***فيكشف الله سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا***ولا تعب أحدًا منهم بما فيكا
فإن لم يصغ له: تركه، ومضى في طريق الأنوار، يبدد ما قد يكون هنالك من بقايا الظلام بنور النصح مع الله الذي أوقده له زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم لما قال:
إذا نصح العبد لله تعالى في سره: أطلعه الله تعالى على مساوي عمله، فتشاغل بذنوبه عن معايب الناس.
فزين العابدين يجعل معرفة المسلم بعيوبه منحة ربانية، و أنها لكذلك والله.
فإذا قرن التائب سكوته ونصحه لله بدعاء يتضرع فيه: كما نوره السابع.
ويستحب له هنا أن يكون خلف عبد الوهاب عزام، يردد مناجاته ربه:
إن في النفس بغضه لأناس***اصلحني وحببنهم إليا
واغسل الحقد والهوى من فؤادي***واجعلني لكل حق وليا.
يقول آمين، وينطلق من فوره بعد ذاك لإتمام أنواره، ويندفع نحو ومضات: النور الثامن، وهو:
صون الأذن عن استماع الغمز
فيدعها في عافية من بعد ما عافى لسانه من تتبع زلات الناس وانتبه لعيوب نفسه، إذ:
ليس من جارحة أشد ضررا على العبد –بعد لسانه- من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب، وأقرب وقوعًا في الفتنة.
فسمعك صن عن قبيح الكلام***كصون اللسان عن النطق به
فإنك عند استماع القبيح***شريك لقائه فانتبه
وهذا ما يستدعيه التعجل الإيماني المستحب للسائر في طريق الأنوار، فإن استماعه للهماز يضيع عليه وقته الثمين إن لم يضره، ويفوت عليه الالتذاذ بمنظر شروق: النور التاسع، الساطع ببريق:
المسارة في نصيحة القادة
فلما لم يعط النبي -صلى الله عليه وسلم- جعيل بن سراقة الضمري رضي الله عنه شيئا من المال، وهو المهاجر المجاهد، وأعطى من هو دونه، وظنها سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه إهمالا لجعيل، وأراد توثيقه: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- مقترحًا:
قال سعد: فساررته قلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلمًا.
فذكر ابن حجر أن هذا الحديث يتضمن من الفقه:
أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان
قال: وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة.
ولما طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكلم بعض الأمراء حول أمر ضجروه منه قال: إنكم لترون أني لا أكلمه؟ إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه؟.
فأخبرهم أنه لم يغفل عن ذلك، وأنه كلمه، ولكن في السر، خوفا أن يستغل أهل الأهواء كلامه، فيتخذونه ذريعة إلى الفتن والمفاسد.
فلهذا يسمي هذا النور: نور أسامة، وما زال يتولي إيقاده من دعاة اليوم كل أسامة.
لا تعن سفاكًا!!
ويصور لنا أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني، وهو أحد قدماء التابعين المخضرمين الثقات ممن أدرك رمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره، مبلغ أساه وندمه وحسرته على كلمات تفوه بها زمن عثمان رضي الله عنه نصحه بهن جهارًا، يظن أن فيه مساوئ، وحاشا الراشد الثالث من المساوئ فتلقف كلماته أصحاب الأغراض، واستباحوا دمه الشريف بهن وأمثالهن.وراموا دم الإسلام لا من جهالة***ولا خطأ، بل حاولوه على عمد
ففي حلقة دراسية انعقدت في المدينة لتدريب وتفقيه الجيل الجديد من رجال دولة الإسلام المكلف باستدراك ما صنعته الفتنة: حاضر عبد الله بن عكيم، وطفق يلخص لهم تجارب المخلصين فقال: لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان.
وكانت كلمة مثيرة منه حقا.
وتأخذ الجميع إطراقة، فما ثم إلا عيون تتبادلا لنظر مستغربة ما يقوله الرجل الصالح.
ما لهذا الشيخ البرئ المؤمن الذي لم يرفع في وجه عثمان سيفا أبدًا يتهم نفسه ويلومها على ما لم يفعل؟
وينبري جزئ لسؤاله:
يا أبا معبد: أو أعنت على دمه؟
فيقول: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه.
فهو يتهم نفسه بجزء من دم عثمان لأنه رأى بأم عينه كيف أن ما ظنه وقام في نفسه من أنه الحق قد أدى إلى استغلال الرعاع له حين يتكلم به، وكيف طوروه حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه.
إنها حساسية النفس الصادقة في توبتها ينطق بها ابن عكيم، مع أنه ما كان يكره عثمان حين تفوه بتلك الكلمات، فإن ابنه يقول: كان أبي يحب عثمان.
وهذا يقتضي أنه قال كلماته الناقدة بلهجة المحب وما فيها من الرفق واللين، ومع ذلك نتج عنها من المفاسد ما نتج، فكيف لو أنضاف إلى علانية النقد لفظ ردئ، وعبرت عنه لهجة عنيفة؟
إن الجيل الجديد من رجال دعوة الإسلام الحديث –إذ هو يتفقه اليوم في حلقاته الدراسية لاستدراك ما صنعته فتن الأمس- مدعو إلى ملاحظة المغزى العظيم المهم لقصة عبد الله بن عكيم، وتجربته الصادقة.
لا تكن ساذجًا أيها الداعية، فإنها تحريشات من حولك لسفك دم الدعوة.
احذر، والتفت إلى عيب نفسك، وصن سمعك وسارر بنصيحتك ونقدك، ولا تعن بلسانك.



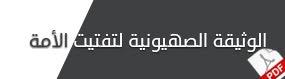









ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق